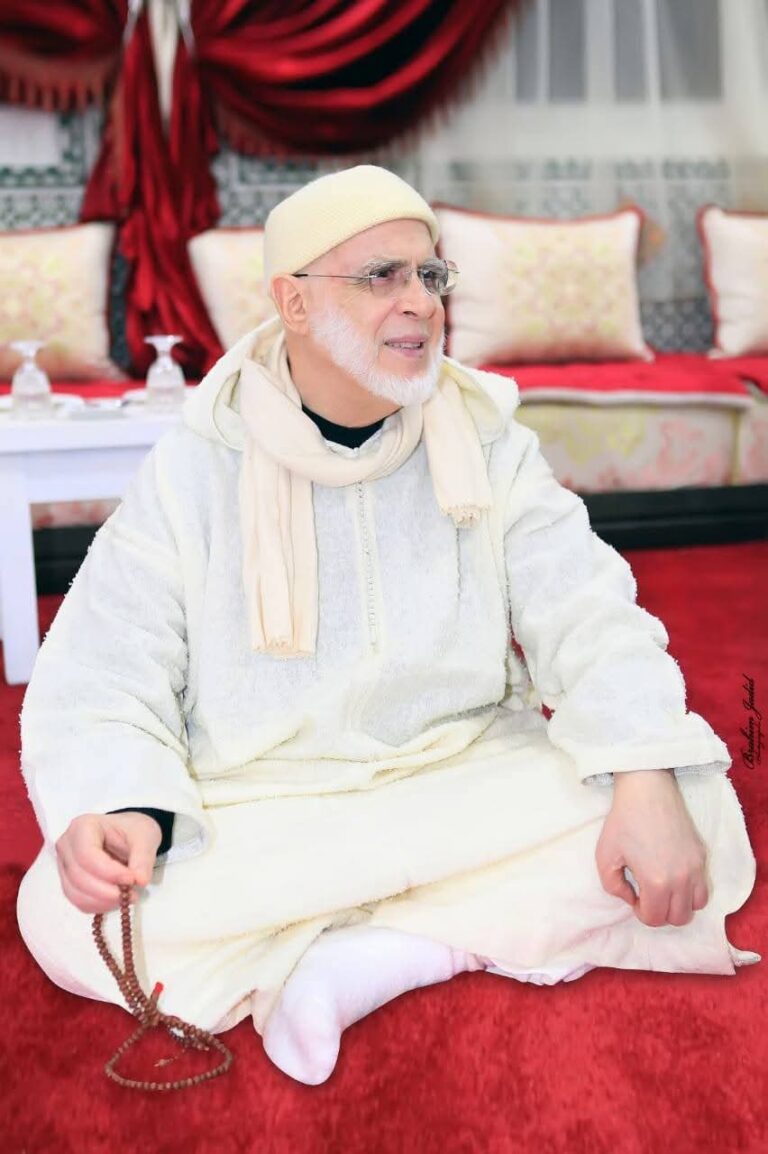هشاشة الإعلام المحلي وسط هيمنة شبكات المال
بقلم: عبد الحق الفكاك
قد نلتمس بعض العذر لمن يرى في الإعلام سلطة كبرى، بل قد نصدّق أن للصحافة سطوة وتأثيراً واسعاً على الناس، خاصة إذا انطلقنا من النماذج الغربية التي أثبتت فيها وسائل الإعلام نفوذها الحاسم في توجيه الرأي العام، والتأثير في توجهات السوق، بل وحتى في نتائج الانتخابات وصناعة النجوم. ففي دول مثل ألمانيا، فرنسا، أو بريطانيا، تتحكم وسائل الإعلام – التي غالباً ما تملكها شركات عملاقة ومجموعات مالية نافذة – في صناعة الذوق العام، وتسويق المنتجات، وتحديد الأجندات السياسية والفكرية.
وفي هذه البيئات، يغدو الإعلام سلطة حقيقية، تتجاوز دور “الإخبار” إلى “التأطير” و”التحكم”، بما يملكه من آليات تقنية، وقدرة على الوصول إلى الأفراد داخل بيوتهم، ووسط أعمالهم، وحتى أثناء لحظاتهم الخاصة عبر هواتفهم الذكية. المواطن هناك، لم يعد يبلور موقفه من القضايا الاجتماعية والسياسية بناءً على تجربته الشخصية أو رأي أسرته، بل من خلال ما يقرأ ويشاهد ويسمع عبر القنوات الإعلامية. إنها سلطة فعلية، وإن كانت غير منصوص عليها في الدساتير، لكنها مؤثرة بقوة تتجاوز أحياناً تأثير السلطات الثلاث التقليدية.
لكن، هل يمكننا إسقاط هذا النموذج على واقعنا الإعلامي المحلي؟ للأسف، لا شيء في الأفق القريب يوحي بأن للصحافة أو للإعلام هذا التأثير أو ذاك الحضور في وجدان المجتمع. فالمشهد هنا مختلف، والصورة قاتمة لا تبعث على التفاؤل.
إن المجتمع الذي يُفترض أن يكون الأرضية الحاضنة لسلطة الإعلام، هو ذاته الذي فقد الكثير من مقومات سلطته الداخلية. الأسرة، التي كانت نواة التنشئة والمرجعية الأولى للأبناء، تراجعت سلطتها بشكل لافت، بعد أن تمرد الأبناء على آبائهم، ولم تعد العلاقة قائمة على الاحترام المتبادل، بقدر ما تحولت إلى صراعات جيلية مفتوحة. والمؤسسات التعليمية، التي كانت سابقاً معقلاً للقيم والمعرفة والانضباط، أضحت اليوم مسرحاً للفوضى والعنف اللفظي والجسدي. لم نعد نندهش لسماع خبر عن أستاذ ضربه تلميذه، أو معلم أُهين من طرف أولياء الأمور في ساحة المدرسة.
وفي ظل هذا التفكك الاجتماعي، أين يمكن أن تتموضع سلطة الصحفي أو المثقف أو رجل الإعلام؟ كيف له أن يوجه خطاباً مجتمعياً، وهو يعلم مسبقاً أنه لن يُقرأ، أو لن يُؤخذ على محمل الجد؟ فالمواطن العادي، في كثير من الأحيان، لم يعد يثق في الجرائد، ولا يتابع القنوات الإخبارية الجادة، بل يكتفي بما يصله عبر مجموعات الواتساب أو منشورات الفيسبوك، حيث يسود التهكم والسطحية والإشاعة.
والمؤلم أكثر أن هذه المنصات، على الرغم من شعبيتها، لا تخضع لأي ميثاق مهني، ولا تلتزم بأي معيار أخلاقي أو قانوني. الأمر الذي يجعل الحديث عن تعددية إعلامية حقيقية، وعن صحافة داعمة للديمقراطية وحقوق الإنسان، أقرب إلى الحلم منه إلى الواقع. فالإعلام هنا لا يملك من أدوات التأثير سوى القليل، ولا من وسائل التمويل سوى ما تجود به السوق الإشهارية التي تتحكم فيها لوبيات المال والنفوذ.
ومع كل هذا، لا ينبغي أن ننكر وجود صحفيين ملتزمين، يشتغلون في صمت، رغم قلة الموارد، وضعف الحماية، وتهميش المؤسسات. هؤلاء، وإن كانوا قلة، فإنهم يشكلون النواة الصلبة لأي مشروع إعلامي نزيه ومهني، وهم الذين يصرون على أن يبقى للإعلام دوره التنويري رغم الإكراهات.
في النهاية، يمكن أن نقرّ بأن الإعلام يتمتع فعلاً بقوة رمزية قادرة على الإقناع والتأثير. لكنه، في غياب شروط الحياد، والاستقلالية، والدعم المؤسسي الحقيقي، سيظل مجرد “سلطة افتراضية”، أو كما يحلو للبعض تسميتها بـ”السلطة الرابعة”. سلطة لا تكتمل إلا إذا ظلت بمنأى عن التجاذبات السياسية، وعن كل أشكال التبعية للسلطات الثلاث الأخرى. فمتى كان الإعلام بوقاً لأحد، فقد مصداقيته، وخسر معركته الأخلاقية، ولو أغرقوه بالمال والامتيازات.
إن السلطة الحقيقية للصحافة لا تنبع من قدرتها على الضجيج، بل من قدرتها على الإنصات، والمساءلة، والاحتفاظ بمسافة نقدية عادلة، تُمكِّنها من أن تكون ضمير المجتمع، لا مروّجاً لأوهامه أو واجهة لأزماته.